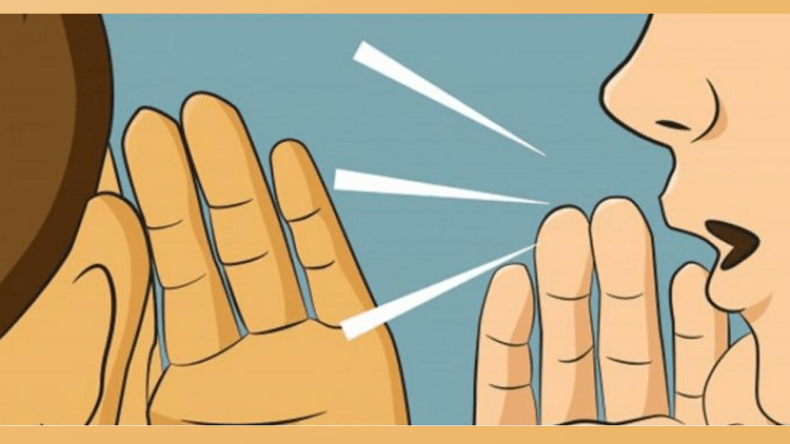في مجتمع لا تزال فيه “الشفهية” تطغى على المكتوب، في كل بيت وفي كل محل، لا يمكن لهذا الوضع الثقافي المتدني إلا أن يدعم ويقوي انتشار الإشاعة.
غير أن الإشاعة اليوم، عبر انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي صارت تمثل أكبر منصة لنشر الإشاعة وتوزيعها وتسويقها آليا، دونما حاجة إلى الشفوية التي تتطلب وقتا لكي تصل إلى الحي المجاور، بعد أن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي المتنقلة بتنقل البشر مع هواتفهم، أسهل وأسرع وسيلة لنقل الإشاعة فورا إلى آلاف الكيلومترات وانتشارها في ثوان عبر الآلاف والملايين من المستعملين.
هذه الوسائط العابرة للوقت والحدود الجمركية والدولية والقانونية أحيانا، تحولت في ظل استعمال غير أخلاقي وبشري النزعة الميالة إلى ترويج لبضاعة دونما الحاجة إلى التيقّن من صحتها أو دقتها، فضلا عن الاستعمال المغرض المنتج لهذه البضاعة والعامل على تسويقها لحاجةٍ في نفسه يعقوب، تحوّلت إلى آلة حربية بامتياز لتخطي الحواجز القانونية والتملّص من الرقابة ونشر قانونها الخاص المتمثل في الفوضى غير المؤسسة: “الفوضى الخناقة”، التي من شأنها أن تخنق الحقيقة وتغطي عليها، بل وتقتلها.
ركون العامّة للتعامل مع الأخبار الكاذبة على أنها حقائق، والتعامل مع الإشاعة على أنها خبر ونبأ، وتبنّي أيّ شكل من هذا النوع من التزييف للحقائق، كان أساسه بدءًا، عدم تصديق الناس والعموم لما تقوله وسائلُ الإعلام الرسمية في مجتمعات شمولية مغلقة، لا تعمل إلا على تحقيق غاية واحدة: نشر الدعاية السياسية، التي غالبا ما تكون مغلوطة أو مفبركة أو مموّهة في نصف الحقيقة، ما جعل المواطن لسنوات طوال لا يركن لتصديق غالبية ما هو رسميّ، فيلجأ إلى سماع وتصديق الإشاعة على أنها “البديل الحقيقي للخبر الممنوع”، هذا دون بذل أي جهد في معرفة مصدر الخبر ومدى صدقيته، فالإشاعة عادة ما تكون بلا مكان ولا زمان ولا فاعل معلوم، أي إنها لا تجيب تماما عن الأسئلة الخمسة المعروفة في تعريف الخبر. مع ذلك، يصدِّقها العقلُ العام، فقط لأن المعلومة المستقاة وبأيّ طريقة نقل أو مصدر ثقة، تعارض المعلومة الرسمية أو تكشف ما لم تقله المؤسسة.
اليوم، نسير في هذا الاتجاه، لنسقط في مستنقعٍ أصعب وأدنى تكون فيه الحقيقة هي الضحية، لكن هذا لأول مرة من جانب المستهلِك وصناع الـ”فاك نيوز” القابعين خلف شاشاتهم وحواسبهم ومكاتبهم الضيقة في غالب الأحيان: مؤسسات وأفراد صاروا يتحكمون في رواج أي منتوج مغلوط وعلى أوسع نطاق وأسرع وقت.
نشر الوهم، ليس أسهل ولا أنقى ولا أفيد من نشر الجهل، ونشر معلومة خاطئة من أيّ طرفٍ كان، تعدُّ جريمة أخلاقية، لأنها تبني على الكذب وتنشره وتوزِّعه لأغراض قد يعرفها “معيد النشر” أو يجهلها أو ينشرها بحسن نيّة، باعتباره لا يمكنه أن يؤكّدها أو ينفيها، لكنه ينشرها دون تعليق ولا تحقيق ولا تحقّق، وكأنه هو من أنتجها ويؤمّن على صحتها. هذا ما يحدث لغالبية مستعملي هذه الوسائط بفعل خاصية سهولة “البارتاج” التي صارت أقوى وسيلة لنشر الفوضى الذّهنية والخبرية بين الناس وبين المستهلكين العامّين للمعلومة بما فيها المعلومة المضلِّلة.
ما نعيشة منذ سنوات ومنذ أشهر ثم منذ أيام، قبيل الفاتح من جانفي 2022، بعنوان “الزيادات المترتقبة في كل المواد بعد جانفي”، هو آخرُ عنوانٍ ضخم لهذه الممارسات التي أربكت المنظومة الاستهلاكية والتجارية.. فقط بسبب الإشاعة.. إشاعة “ويلٌ للمواطن من الزيت”، التي تصبُّ على نار باقي الأسعار الملتهبة منذ أشهر.